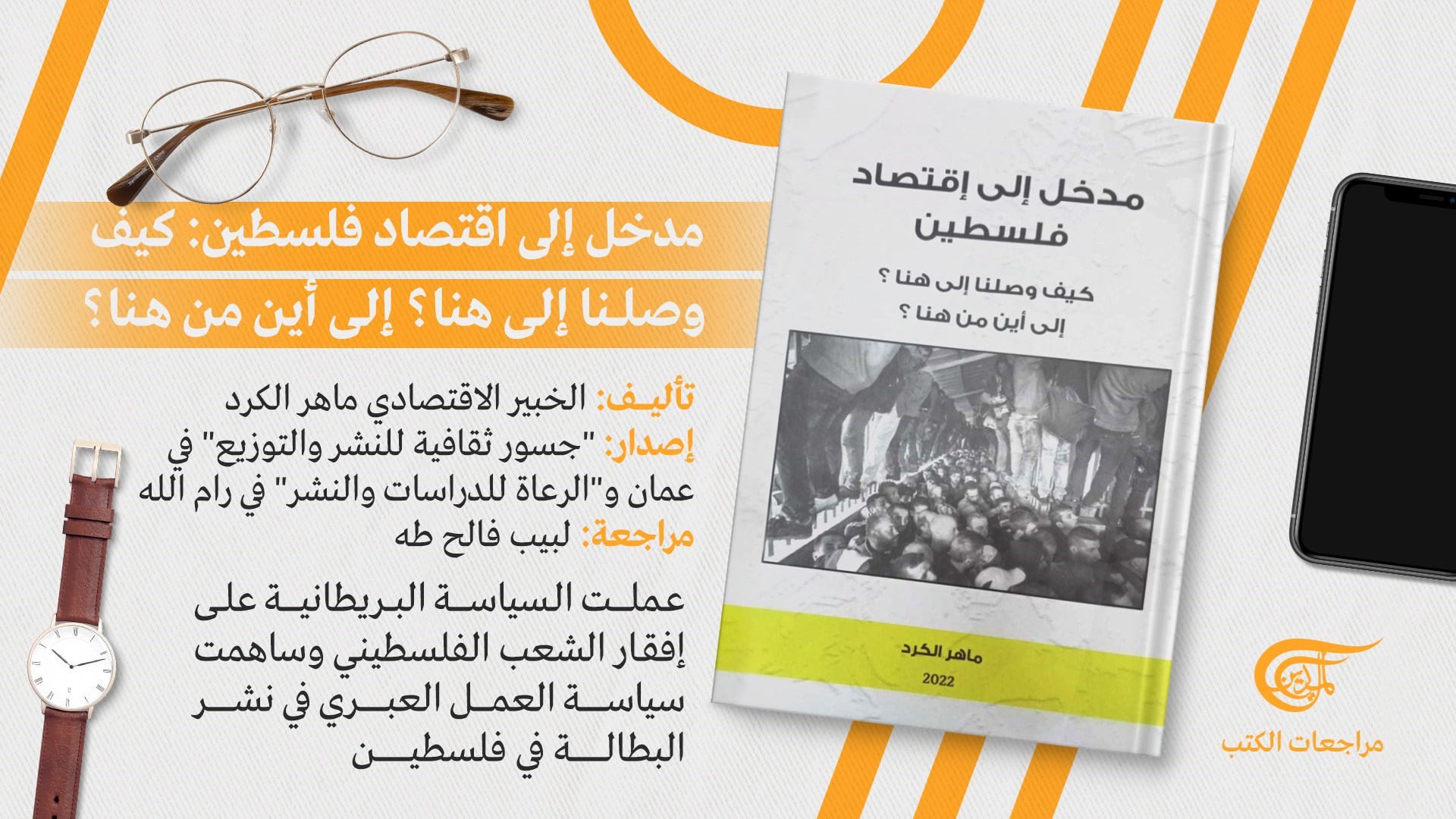
فلسطين كانت على أعتاب مرحلة تحول وتطور اقتصادي عندما وقعت تحت الاحتلال البريطاني الهادف إلى تحقيق المشروع الصهيوني، لتبدأ مرحلة التدمير والاقتلاع لكل ما هو فلسطيني.
لبيب فالح طه
19 تموز 2023 13:40
صدر عن “جسور ثقافية للنشر والتوزيع” في عمان، و”الرعاة للدراسات والنشر” في رام الله، كتاب “مدخل إلى اقتصاد فلسطين-كيف وصلنا إلى هنا؟ إلى أين من هنا” من تأليف ماهر الكرد. جاء الكتاب في (342) صفحة من القطع المتوسط، وصورة غلاف لعمال فلسطينيين في وضع بائس على حاجز “ترقوميا” الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية.
مؤلف الكتاب من مواليد مدينة القدس، درس في الجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة “لايبزيج” في ألمانيا. عمل مستشاراً اقتصادياً في مؤسسة “ووترهاوس – أبو غزالة”، ولرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومدير ونائب رئيس مؤسسة “صامد”، رئيس إدارة التخطيط في الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الاقتصادية لحركة فتح، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وأستاذ في جامعة القدس.
يقول المؤلف عن المقاربة التي تتبعها دراسته إن الوضع القائم هو نتاج مركب لعوامل تاريخية وأيديولوجية واقتصادية وسياسية؛ ولذا سيستعرض هذه العوامل، ويشخص الوضع القائم، والإمكانات المتاحة للانتقال منه. يقول الباحث عن كتابه إنه غير موجه للأكاديميين والباحثين، وإنما الشبيبة والقراء غير المتخصصين.
يبدأ الكتاب بالحديث عن فلسطين في سياق تاريخي، ويتناول المقاربة الغربية الاستشراقية التي تختزل تاريخ فلسطين في فترة مملكتي يهودا والسامرة، وهي المقاربة التي رفضها العديد من الأكاديميين والباحثين بمن فيهم نورمان فينكلشتاين والمؤرخ بنيامين مازار من جامعة “تل أبيب” والفيلسوف شلومو ساند مؤلف الكتابين “اختراع الشعب اليهودي” و”اختراع أرض إسرائيل”.
يخلص الباحث إلى أن المشروع الاستيطاني الصهيوني تطلب تدمير الوجود الفلسطيني بمقوماته كافة، إذ زعم القائمون عليه أن الهوية الفلسطينية لم تبرز إلا كرد فعل على مشاريع الحركة الصهيونية- في حين يظهر أن الاسم قد تم تداوله في العام 1701، وينقل الباحث عن المؤرخ الإسرائيلي حاييم جيربر أن فلسطين كانت شبه دولة منذ القرن السابع عشر عندما قسمتها الدولة العثمانية إلى ثلاثة سناجق – وما دام يلزم تدمير الوجود الفلسطيني، فإن المكوّن الاقتصادي يقع في دائرة الاستهداف حتماً.
يتحدث الباحث عن ملكية الأراضي نهاية عهد العثمانيين؛ حيث سمحت أنظمة “التيمار” – وهو نظام يقوم على إعطاء أراض من السلاطين العثمانيّون للفرسان والأفراد الذين يخدمون في العسكريّة – للتجار والعشائر والأجانب بتملك الأراضي، وملكية الأراضي مثلت بالطبع قوة اقتصادية واجتماعية في فلسطين. كما أن حملة إبراهيم باشا على فلسطين وغيرها – التي قام خلالها بتنفيذ ترتيبات إدارية ومؤسسية واقتصادية – مثلت التأثير الخارجي الأول في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، لكن الباحث لم يذكر الترتيبات أو آثارها. الدعم الأوروبي للعثمانيين في هزيمة إبراهيم باشا كان أحد أثمانها يتمثل في فتح الدولة العثمانية أبوابها أمام النفوذ الاقتصادي الأوروبي. كما أن نظام الطابو، جعل الأرض سلعة، ووسع الإنتاج الزراعي، وأصبح هناك تبادل تجاري مع المحيط العربي وأوروبا. هذا الشيء أوجد طبقة تجارية وأثّر في العلاقة بين ملاك الأراضي والمزارعين.
تملك الأراضي أصبح متاحاً بالطبع بصورة أكبر لفئة الأعيان الذين تملكوا مساحات واسعة من أراضي القرى الزراعية. هذا الشيء أدى إلى حرمان الفلاحين من الحيازة الزراعية، وتحولوا إلى عمال يبيعون قوة عملهم أو مهاجرين إلى المدن للعمل هناك. التطورات الاقتصادية وما رافقها من تحسين وسائل المواصلات الداخلية والخارجية، وتحسين مدخلات الإنتاج وأدواته أدت إلى تحولات جوهرية في البنية الاقتصادية، وإلى التحوّل الرأسمالي بشكل متسارع، ونمو الفائض الاقتصادي بشكل كبير. التطورات المذكورة جعلت فلسطين تقف على عتبة نهضة اقتصادية واجتماعية. في ظل التطورات السالفة الذكر، نمت طبقة برجوازية تجارية وتوسع دور المؤسسات المصرفية، فأطلقت مشروعات استثمارية كان منها مشروع القطار الخفيف الذي يعمل بالطاقة الكهربائية في القدس وغيرها، ومع ذلك فالسردية الصهيونية تقدم فلسطين في تلك الفترة على أنها كانت تحت سلطة عثمانية رجعية وجامدة ومتخلفة.
يتضح مما سبق أن فلسطين كانت على أعتاب مرحلة تحول وتطور اقتصادي عندما وقعت تحت الاحتلال البريطاني الهادف إلى تحقيق المشروع الصهيوني، لتبدأ مرحلة التدمير والاقتلاع لكل ما هو فلسطيني.
وضع الانتداب البريطاني يده على نفط فلسطين عبر شركة (شل) الملكية، وربط ميناء حيفا بالعراق ليتم نقل النفط عبر ميناء حيفا إلى أوروبا. تنمية ميناء حيفا وتوسيعه أديا إلى توسيع العمالة في فلسطين.
السياسة البريطانية عملت على إفقار الشعب الفلسطيني، سياسة العمل العبري ساهمت في نشر البطالة في فلسطين، فالسياسة البريطانية سمحت بإنشاء الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية وفيدرالية العمل العبري (الهستدروت) وإنشاء مصارف مثل (هبوعليم). كما أعطتهم امتياز روتنبرغ لتوليد الطاقة الكهربائية وامتياز استخراج المصادر المعدنية واستغلال بحيرتي طبريا والحولة.
خلال الحروب التي جرت بين العرب والإسرائيليين كان الإسرائيليون يقومون بإجراءات لصالحهم تضر بالوضع الاقتصادي الفلسطيني؛ فبعد حرب 1948 تم قطع الصلة بين الضفة الغربية وغزة وبقية فلسطين التاريخية، وقد خسرت الضفة وغزة مساحات واسعة من الأراضي الخصبة وموارد المياه (غزة خسرت ثلث مساحتها). كما وصل إليها طوفان بشري من لاجئي المناطق المحتلة عام 1948 ما شكل ضغطاً على مواردهما المحدودة. كما خرج من الضفة الغربية وغزة أصحاب رؤوس أموال وكوادر علمية وبشرية إلى الشتات.
كانت خسائر فلسطين عام 1948 بحسب لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة عن الأراضي المملوكة بشكل شخصي مبلغ 235,660,250 جنيهاً فلسطينياً، وهو ما يعادل 824,780,808 دولار أميركي، وفقاً لتقديرات المؤرخ الاميركي ميخائيل فيشباخ عام 2003 بأسعار عام 1948 – وفيشباخ هو الذي أوكلته “الأمم المتحدة” توثيق أوراق ملكية الفلسطينيين -. أضف إلى ذلك منشآت كميناء حيفا والمطار والطرق والسكك الحديدية وغيرها. كما أن قوانين إسرائيلية وضعت لنهب الأملاك الفلسطينية تحت مسميات مثل “قانون أملاك الغائبين” وغيره.
الفلسطينيون الذين بقوا في المناطق المحتلة عام 1948 سلبت منهم أراضيهم بمعظمها، وأصبحوا يسكنون فيما يشبه مخيمات العمال التي تخدم المشروع الاستعماري الصهيوني.
بعد حرب عام 1967، صادرت “إسرائيل” مساحات شاسعة من الضفة الغربية وغزة تحت مسمّيات عدة، كما أصبحت المياه بالطبع تحت سيطرتهم وأصبح الغلاف الجمركي الإسرائيلي يضم المناطق المحتلة. كان من نتائج المصادرة للأرض والمياه انخفاض نسبة العاملين في الزراعة في الضفة وغزة، كما تراجع الإنتاج الصناعي أيضاً من 8.3% إلى 6.9% بين الأعوام 1969-1983.
أسواق الضفة الغربية وغزة أصبحت سوقاً للبضائع الإسرائيلية وتم فرض قيود على تصدير منتجات الضفة وغزة إلى “إسرائيل”، كما أن دخول المناطق المحتلة في إطار النظام الاقتصادي الإسرائيلي نشأ عنه الكساد التضخمي بسبب التحويلات الخارجية من عدة مصادر، والانكشاف الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي من دون أي قدرة على المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والتجارية، الكساد التضخمي ساهم أيضاً في رفع تكاليف العمالة والطاقة وغيرها في فلسطين مقارنة مع مثيلاتها في الدول العربية ما أفقد الصادرات الفلسطينية ميزتها التنافسية.
تراجع قطاع الزراعة بما يقارب نصف القوى العاملة إلى 27% عام 1986 نتيجة الممارسات الإسرائيلية. عقود العمل من الباطن تؤول القيمة المضافة من هذه النشاطات الإنتاجية بالكامل إلى الاقتصاد الإسرائيلي. الضرائب التي جبتها “إسرائيل” وخسائر إيرادات من امتياز إصدار العملة هي خسائر للفلسطينيين. تراجع الوضع الاقتصادي بسبب خروج الفلسطينيين من الخليج عقب حرب 1991.
السياسات الإسرائيلية التي ورثت الظلم والاحتلال البريطاني سعت لإفقار الشعب الفلسطيني؛ كان لها عدة أوجه منها الإغلاقات التي تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية يتكبدها العمال والطلاب ومختلف قطاعات المجتمع. مثلاً، خلال الانتفاضة الثانية، بلغت الخسائر خلال العامين الأولين 5200 مليون دولار، كما انخفضت الإيرادات العامة، وازدادت نسبة الفقر لتصل إلى 50% في الضفة و75% في غزة عام 2002. بالنسبة إلى غزة، تناقص عدد شاحنات البضائع التي تدخل وتخرج من غزة بعد العام 2006، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأفراد. في الفترة بين 2006-2018 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%، كما انخفضت نسبة مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي من 31% عام 2006 إلى 18% عام 2018. الحصار على غزة أدى إلى تخفيض صادراتها إلى الضفة بنسبة 85%، وكادت التجارة الخارجية تكون منعدمة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، كما أن “إسرائيل” تضيق على الصيادين وعلى المزارعين الذين تحاذي أراضيهم منطقة الخط الأخضر، أضف إلى ذلك تخلف المانحين عن إعادة إعمار ما خلفته الحروب الإسرائيلية على غزة.
في القدس التي تشكل السياحة عنصراً مهماً في اقتصادها تضررت الفنادق، فانخفض عدد الغرف الفندقية من 1403 عام 2015 إلى 984 عام 2019. قدرت الأونكتاد أن الاحتلال تسبب في خسائر بقيمة 57.7 مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني بين فترتي 2000-2019. جدار العزل الإسرائيلي الذي أقيم بعد عام 2000 التهم 10% من أراضي الضفة الغربية التي تقع على مناطق المياه الجوفية.
سعت “إسرائيل” لتخلف الفلسطينيين عن مستوى التقنية؛ فشبكات الاتصالات هي في الجيل الثاني في غزة والثالث في الضفة الغربية في حين أنها وصلت إلى الجيل الخامس في “إسرائيل” ومعظم الدول العربية.
كانت نتائج بروتوكول باريس الاقتصادي سلبية إلى حد كبير للشعب الفلسطيني؛ في المفاوضات التي أجرتها منظمة التحرير الفلسطينية مع البنك الدولي نهاية عام 1993 وحتى صيف 1994 اشترط الأخير أن تعتمد السلطة الفلسطينية سياسة اقتصادية ليبرالية تستند إلى المشروع الخاص وحرية السوق وحرية التجارة، وتمتنع عن إقامة مشروعات للقطاع العام أو برامج لدعم الاستهلاك. كما أن حصر إيراداتها من الرسوم والضرائب في مناطق ولايتها “أ” و “ب” ولا تشمل منطقة “ج” أو القدس حدّ من موارد السلطة الفلسطينية وإمكاناتها.
آلية المقاصة – وهي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه – التي هي أكبر مصدر لإيرادات السلطة الفلسطينية تعتمد إجراءات بيروقراطية تقوم على توثيق مستندات الاستيراد وفواتير المبيعات الضريبية وضرائب الشراء والمكوس؛ وينتج منها تسرب مالي يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوقفت “إسرائيل” المقاصة النقدية ولا يقبل بنك “إسرائيل” بعقد اجتماع سنوي لتحديد كمية النقد القابل للتحويل، ولا تتحاور “إسرائيل” مع السلطة الفلسطينية حول إصدار عملة فلسطينية، والضرائب على العمل حولتها “إسرائيل” ثلاث مرات من دون إطلاع وزارة المالية الفلسطينية بشأنها أو عن تفاصيلها. كما لم تنفذ “إسرائيل” مستحقات تأمين التقاعد للعمال الفلسطينيين التي تجبيها “إسرائيل” من العمال منذ عام 1970. في الشؤون البيطرية الإسرائيلية، لا تعترف بنظيرتها الفلسطينية ما يعيق تصدير المواشي إلى “إسرائيل”. كما تمتنع “إسرائيل” عن منح الشركات والحافلات السياحية التراخيص التي نصت عليها الفقرتان السادسة والسابعة من اتفاق باريس، كما أن شركات التأمين الإسرائيلية لا تعترف بشهادات التأمين الصادرة عن الشركات الفلسطينية.
الاستيراد المباشر وضعت “إسرائيل” أمامه عراقيل تمثلت في تأخير إجراءات التخليص الجمركي، ومنع وجود ممثلي المستوردين في المنافذ الجمركية والفحص الأمني المتشدد.
من ناحية سياسات السلطة الفلسطينية الاقتصادية، فإن الباحث يعترض على العديد من سياساتها؛ فالتوسع في التوظيف في الأجهزة الأمنية سيكون على حساب خدمات أخرى.
قبل دخول عرفات إلى غزة، قام محمد رشيد (أو خالد سلام) بالتوقيع على عقد احتكار وتوزيع منتجات شركة “نيشر” الإسرائيلية للأسمنت. كما قام كل من بيير رزق المسؤول السابق في القوات اللبنانية عن التنسيق مع “إسرائيل”، واليهودي المغربي غابرييل بانون بإنشاء عدد من الحسابات الخارجية للسلطة في الخارج. كما وقع ياسر عرفات على احتكار الاتصالات لصالح شركة ITI التي تمتلك معظم أسهمها مجموعة من الأميركيين اللبنانيين المنتمين إلى تنظيم القوات اللبنانية.
تم إنشاء شركة “الخدمات التجارية” التي رتبت بيع المشتقات النفطية لصالح شركتي “دور” و”نيشر” الإسرائيليتين في السوق الفلسطينية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وتم تكليف بعض الأجهزة الأمنية بتلك المهام مقابل نسبة من العائدات.
في ما بعد، تم تعطيل دور الجهات الرقابية من مجلس تشريعي وغيره في مجال الاحتكارات وسوء الإدارة.
في فترة سلام فياض، تقاعد نحو 20,000 عنصر أمن واستبدل بهم آخرون ما حمّل الخزينة العامة نفقات إضافية.
ومما يعوق الاستثمار كان الحصول على التمويل، إذ قدمت عام 2014 المصارف ائتماناً محلياً بقيمة 1.7 مليار دولار، في حين استثمرت 3 مليارات في الخارج ما يعكس عدم الثقة في الاقتصاد المحلي.
يرى الباحث أن السلطة حين تخصخص فإنها أقرب إلى تبديد الموارد، وأن المستثمرين في الخارج لا يستثمرون في فلسطين إلا إذا وجدت لهم روابط مع السلطة الفلسطينية. كما أن استثماراتهم لم تكن عبر تحويل أموالهم من الخارج، وإنما كانت من الامتيازات الاحتكارية التي حصلوا عليها نتيجة لعلاقاتهم مع قيادات السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية لا تملك أدوات تمكنها من إدارة السياسات الاقتصادية من العملة الوطنية والقدرة على التحكم بأسعار الفائدة ونسب الجمارك ونسب الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة.
يخلص الباحث إلى أنه من الصعب القول بوجود “اقتصاد فلسطيني»”، فصلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق “أ” و”ب” لا تشمل “ج” ولا القدس أو غزة. الوضع المذكور أعلاه فاقم رجل الشارع الفلسطيني إذ تكاد تكاليف المعيشة في “إسرائيل” تتماثل مع الأراضي الفلسطينية مع فارق دخل كبير بين الطرفين.
يعرض الباحث طروحات البعض عن المخرج للأزمة الاقتصادية الفلسطينية، فينقل عن الباحثة الفلسطينية في مجال الإقتصاد السياسي ليلى فرسخ أن الجدوى الاقتصادية لإقامة دولة فلسطينية ممكنة إذا كانت كاملة السيادة على أرضها ومصادرها المائية والطبيعية وحدودها وسياساتها التجارية والمالية والنقدية، أما المؤرخ الفلسطيني فضل النقيب فيرى ضرورة معالجة قضايا مثل تأثير السياسات الاستعمارية في تشوّه الاقتصاد الفلسطيني، وجود فئات مستفيدة من استمرار الاحتلال، وتفكيك الهياكل الاقتصادية والتشوهات الناجمة عن الفصل بين معدلات نمو الدخل عبر العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ومعدلات نمو الناتج المحلي. ويقترح أن تمارس السلطة الفلسطينية دور «الدولة التنموية» عبر سياسة إحلال الواردات، وتنمية رأس المال البشري، وتنشيط القطاع التصديري في التجارة الخارجية، والتوزيع العادل للدخل القومي؛ فالمقاربة الليبرالية التي تدعو إلى الانفتاح وحرية التجارة والتكامل لا تؤدي إلا إلى احتواء الاقتصاد الإسرائيلي للفلسطيني أو التبعية الكاملة.
يرى الباحث في النهاية أن الحل يكمن في تفكيك الاستعمار، المطالبة بحقوق متساوية، النضال الشعبي، حركة المقاطعة، التخلي عن النيوليبرالية وتبني استراتيجية التنمية الوطنية، تعزيز المجتمع المدني واقتصاد الصمود ورفض الوضع القائم بكل الأشكال والوسائل الممكنة.
في النهاية أقول إن الكتاب عالج السؤالين اللذين طرحهما العنوان وهما كيف وصلنا إلى هنا؟ إلى أين من هنا؟ فقد وصلنا إلى هنا بفعل السياسة الاحتلالية الإسرائيلية وقبلها البريطانية، وأن المخرج لا يكون بتبني السياسة النيوليبرالية وتوزيع الاحتكارات وغيرها من السياسات الخاطئة، وإنما برؤية تنموية لا أظن أن الاحتلال سيسمح بها، ولكن يمكن تحقيقها إلى حد كبير

